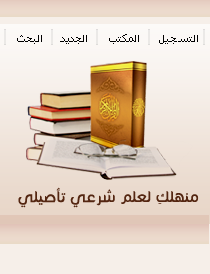

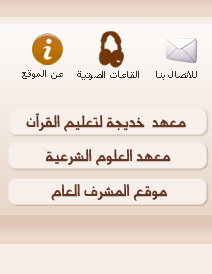
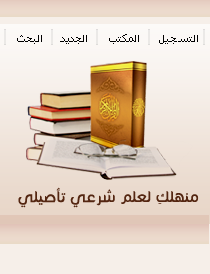 |
 |
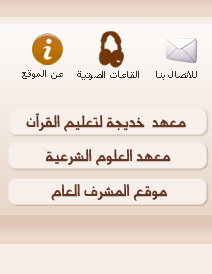 |
|
|
|
|
#1 |
|
نفع الله بك الأمة
|
"عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا" 18. قيل :السلسبيل وصف مشتق من السلاسة بمعنى السهولة واللين، يقال: ماء سلسل، أي:عذب سائغ للشاربين، ومعنى تُسَمَّى على هذا القول أي: توصف بالسلاسة والعذوبة. وقيل: السلسبيل: اسم لهذه العين، لقوله-تبارك وتعالى- تُسَمَّى. أي: أن هؤلاء الأبرار- بجانب كل ما تقدم من نعم ؛ يسقون- أيضًا- من عين فيها- أي: في الجنة- تسمى سلسبيلا، وذلك لسلاسة مائها ولذته وعذوبته، وسهولة نزوله إلى الحلق. "وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا" 19.. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ :ويَطوفُ على الأبرارِ في الجنَّةِ بالشَّرابِ أو غَيرِه. والطواف : مشي مكرر حول شيء أو بين أشياء . وِلْدَانٌ : أولادٌ صِغارٌ على سنٍّ واحِدةٍ، فلا يَهرَمونَ ولا يموتونَ.، ويطلق الوليد على الصبي مجازًا مشهورًا بعلاقة ما كان ، لقصد تقريب عهده بالولادة ، وأحسن ما يُتخذ للخدمة الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشيًا ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم . مُّخَلَّدُونَ : دائمون على ما هم عليه من النضارة والشباب ، ووصفوا بأنهم مخلدون للاحتراس مما يوهمه اشتقاق ولدان من أنهم يَشُبُّون ويكتهلون ، أي لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دومًا وإلا فإن خلود الذوات في الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص . إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا: إذا رأيتَهم ظَنَنْتَهم -لحُسْنِهم وانتِشارِهم لخِدمةِ الأبرارِ- لُؤلؤًا مُفَرَّقًا. إذا رأيتَهم في انتِشارِهم لخِدمةِ الأبرارِ ، وكثرتهم ، وصباحة وجوههم ، وحسن ألوانهم وثيابهم وحُليهم ، حسبتهم لُؤلؤًا مُفَرَّقًا . ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. "وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا"20. ثَمَّ : ثم هنا ظرف مكان. مختص بالبعيد .معناه: أن بصرك أينما وقع في الجنة رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا عَظيمًا هنيئًا واسعًا -أهلَ الجَنَّةِ كلَّهم ملوكٌ فيها - وسُلطانًا باهِرًا أعَدَّه اللهُ تعالى للأبرارِ. وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول . " عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا"21. لفظةُ: عَالِيَهُمْ : تدل على كَونِ ذلك اللِّباسِ ظاهِرًا بارِزًا يُجَمِّلُ ظواهِرَهم، ليس بمَنزِلةِ الشِّعارِ الباطِنِ، بل الَّذي يُلبَسُ فوقَ الثِّيابِ للزِّينةِ والجَمالِ. قال الطبري في التفسير: والسندس: هو ما رق من الديباج، والإستبرق هو الديباج الغليظ. الدِّيباج هو نَسيج مِنَ الحرير الأَصيلِ، مُلَوَّنٌ أَلْوانًا مُخْتَلِفَةً وتصنع منه ثِياب ظاهرها وباطنها من الحرير. والمعنى: أن هؤلاء الأبرار، أصحاب النعيم المقيم، والمُلك الكبير، عليهم ثيابٌ مِن حريرٍ رقيقٍ ، ومِن فَوقِها ثيابٌ مِن حريرٍ غَليظٍ له بَريقٌ ولَمَعانٌ على سبيل التنعم والجمع بين محاسن الثياب. وكانت تلك الملابس من اللون الأخضر، لأنها أبهج للنفس، وشعار لباس الملوك. ثلاثة حُببت للناس : الماء والخضرة والوجه الحسن. فَرُغِّبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة. وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول مع اعتقاد "في الجنةِ ما لا عينٌ رأت ولا أُذُنٌ سمِعَت ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ."خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند. عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهُما قال : ليسَ في الجنَّةِ شيءٌ مِمَّا في الدُّنيا إلَّا الأسماءُ" خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب . وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ: والمعنى أن المؤمن يحلى في الجنة بالفضة. والأساور : جمع سوار وهو حُلي شكله أسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك. كان الملوك فى الزمان الأول يحلون بها ويسورون من يكرمونه. قال صلى الله عليه وسلم "تبلغُ الحِلْيةُ من المؤمِنِ حيث يبلُغُ الوضوءُ "خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم : 2911 -التخريج : أخرجه مسلم:250. "كُنْتُ خَلْفَ أبِي هُرَيْرَةَ وهو يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، فَكانَ يَمُدُّ يَدَهُ حتَّى تَبْلُغَ إبْطَهُ فَقُلتُ له: يا أبا هُرَيْرَةَ ما هذا الوُضُوءُ؟ فقالَ: يا بَنِي فَرُّوخَ أنتُمْ هاهُنا؟ لو عَلِمْتُ أنَّكُمْ هاهُنا ما تَوَضَّأْتُ هذا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ."الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. يستفاد من الحديث: استحباب إتمام الوضوء، وإسباغه. ومما يتزين به المؤمنون يوم القيامة الحلي. تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ:أي تصلُ زينة المؤمن يوم القيامة إلى ما يصل إليه الماء الذي يتوضأ به، والوضوء يبلُغ إلى المرافق، وعلى هذا يكون الذراع كله مملوءًا بالحلية، نسأل اللّه تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يُحلَّون بهذا الحُلِيِّ. والمراد بالحلية:ما يُتزينُ به من الأساور، ونحوها، وقيل: النور. شرح الحديث: في هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ أبو حازمٍ الأشجعيُّ أنَّه كانَ واقِفًا خَلْفَ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فَكانَ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه يَغسِلُ يَدَيه وذِراعَيه إلى أن يَبلُغَ الإبطَينِ؛ مُبالَغةً ورَغبةً في غَسلِ أطوَلِ جُزءٍ مِنَ الذِّارعَينِ، فسألَه أبو حازمٍ عن سببِ هذا الوُضوءِ الذي لم يَعهَد أن يَرَى أحدًا يَتوضَّأُ مِثلَه، فقالَ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه"يا بَنِي فرُّوخَ، أنتُم هاهُنا؟" أي: حاضِرُونَ وتَرَوني، وبَنُو فرُّوخَ: هُمُ العَجَمُ، وقيلَ: إنَّ فرُّوخَ من وَلدِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وهُو أخو إسماعيلَ وإسحاقَ، ومِن ولدِه العَجَمُ، ثُمَّ أخبَرَ أنَّه لو يَعلَمُ أنَّ أحدًا يَراه ما تَوضَّأ هذا الوُضوءَ. وأرادَ أبو هُرَيرةَ بكَلامِه هذا أنَّه يَنبَغي لمَن يُقتدى به إذا تَرخَّصَ في أمرٍ أو تَشدَّدَ فيه مع نفسِه، أو لاعتقادِه في ذلك مَذهَبًا شَذَّ به عنِ النَّاسِ: ألَّا يَفعَلَه بحَضرةِ العامَّةِ؛ لئلَّا يَترخَّصوا برُخصتِه لغَيرِ ضَرورةٍ أو يَعتقِدُوا أنَّ ما تَشدَّدَ فيه هو الفرضُ. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: حلية المؤمن في الجنة، أبو هريرة فعل هذا ليُزاد له في الحلية، جاء في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فجعل يزيد حتى تكون الحليةُ تستمر، ولكن هذا لا يدل على شرعية الزيادة، يكون مبلغ الحلية مبلغ الوضوء إلى منتهى المرفقين، ما بعد المرفقين.ا.هـ. وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا أخفى وضوءه، وقال لما أُنكر عليه: لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء.كتاب شرح سنن النسائي – الراجحي. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا : أُسنِدَ سَقْيُ الشَّرابِ إلى ربِّهم؛ إظهارًا لكَرامتِهم، أي: أمَر هو بسَقْيِهم، كما يُقالُ: أطْعَمَهم رَبُّ الدَّارِ وسَقاهم . أو أُسنِدَ سَقْيُه إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه أُرِيدَ به نوعٌ آخَرُ يَفوقُ على النَّوعينِ المُتقدِّمَينِ. وجاء لفظ " طَهُورًا" بصيغة المبالغة، للإشعار بأن هذا الشراب قد بلغ النهاية في الطهارة.شَرَابًا طَهُورًا: طاهر مطهر .فالطاهر ليس بالضرورة مطهِّر فكثير من السوائل طاهرة لكنها ليست بالضرورة مطهِّرة. واستعمال طَهُور هنا مناسب لسياق الآيات وتشتمل المعاني كلها الطاهر والمطهر والمبالغة فيهما. عبارة طهور أنها لم ترد في القرآن إلا في موردين: أحدهما في مورد المطر "وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا "الفرقان 48 .الذي يطهر كل شئ ويحيي البلاد الميتة، والآخر في مورد الآية التي نحن بصدد بحثها، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا: وهو الشراب الخاص بأهل الجنة. ولم يذكر الكتاب ما يبين نوع ذلك الشراب، فلندع أمره إلى الله."إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا"22 .ثم ختم- سبحانه - هذا العطاء الواسع العظيم، ببيان ما يُقالُ لهم، أو يقولُ لهم ربُّهم، عند تمتعهم بكل هذا النعيم، إِنَّ هذا النعيم الذي تعيشون فيه كانَ لَكُمْ جَزاءً على إيمانكم وعملكم الصالح في الدنيا.وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا:أي: مرضيًا ومقبولًا عند خالقكم، فازدادوا- أيها الأبرار- سرورًا على سروركم، وبهجة على بهجتكم. والإتيانُ بفِعلِ كَانَ في قولِه تعالى: وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ؛ للدَّلالةِ على تَحقيقِ كَونِه سَعْيًا مَشكورًا. وشكره للعبد قبول طاعته ، وثناؤه عليه ، وإثابته إياه. وبعد هذا التفصيل لما أعده الله-تبارك وتعالى- لعباده الأخيار من أصناف النعيم، المتعلق بمأكلهم، ومشربهم.. أخذت السورة الكريمة.
في أواخرها- في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.فقال عز من قائل: |
|
|

|
|
|
#2 |
|
نفع الله بك الأمة
|
"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا "23. يقولُ تعالى مثبِّتًا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ -يا محمَّدُ- الْقُرْآنَ تَنزِيلًا مُفَرَّقًا. القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء جملة واحدة ، بل كان ينزل مُفَرَّقًا حسب الحوادث والأحوال .وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد جاءت الآيات تقرر ذلك بوضوح تام لا لبس فيه ، وتقرر حكمة النزول على تلك الصفة :قال تعالى " وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا"سورة الإسراء: 106. فَرَقْنَاهُ :قال الحسن : معناه فَرَقْنَا به بينَ الحقِّ والباطلِ. وقال الطبري في تفسيرهِ:اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء الأمصار "فَرَقْناهُ" بتخفيف الراء من "فَرَقْناهُ" ، بمعنى: أحكمناه وفصلناه وبَيَّناه . وذُكِرَ عنِ ابنِ عباسٍ، أنه كان يقرؤه بتشديد الراء " فَرَّقْناهُ" بمعنى: نزَّلْنَاه شيئًا بعد شيءٍ، آية بعد آية، وقصة بعد قصة.وأَوْلَى القراءتين بالصواب عندنا، القراءة الأُولَى، لأنها القراءة التي عليها الحجة مجمعة، ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من أمر الدين والقرآن ، فإذا كان ذلك أولى القراءتين بالصواب، فتأويل الكلام: وما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا، وفصلناه قرآنا، وبيَّناه وأحكمناه، لتقرأه على الناس على مكث.ا.هـ. عَلَى مُكْثٍ: أي على مهل وتُؤدة ليفهموه.قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله :عَلَى مُكْثٍ : أي - على مهل ، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه . "وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزيلاً " أي: شيئًا فشيئًا مفرَّقًا في ثلاث وعشرين سنَة .انتهى من " تفسير السعدي " ص 468 وقال تعالى " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً"الفرقان: 32. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ :قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله : لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينةً وثباتًا ، وخصوصًا عند ورود أسباب القلق ؛ فإن نزول القرآن عند حدوث السبب ، يكون له موقع عظيم ، وتثبيت كثير.ا.هـ. ومما يؤكد نزول القرآن مُفَرقًا أيضًا : انقطاع الوحي في حادثة الإفْكِ الَّتي اتُّهِمتْ فيها أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها في عِرضِها بُهتانًا وكَذِبًا؛ ، وقد انتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن ؛ لعظيم وقع المصيبة بتهمة زوجه حتى نزل قوله تعالى " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ " النور/ 11 . " ........ فَوَاللَّهِ ما رَامَ مَجْلِسَهُ ولَا خَرَجَ أحَدٌ مِن أهْلِ البَيْتِ، حتَّى أُنْزِلَ عليه الوَحْيُ، فأخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ ، حتَّى إنَّه لَيَتَحَدَّرُ منه مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ في يَومٍ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَضْحَكُ، فَكانَ أوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهَا أنْ قَالَ لِي: يا عَائِشَةُ، احْمَدِي اللَّهَ؛ فقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ، فَقَالَتْ لي أُمِّي: قُومِي إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقُلتُ: لا واللَّهِ، لا أقُومُ إلَيْهِ، ولَا أحْمَدُ إلَّا اللَّهَ، فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى" إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ"النور: 11. الآيَاتِ........" الحديث. الراوي : عائشة أم المؤمنين - صحيح البخاري. أما الذي وقع الخلاف فيه ، فهو أول وأصل نزول القرآن : هل نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ، ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقًا ، أو كان نزوله على صفة واحدة ، مفرقًا حسب الوقائع ، كما سبق . وسبب ذلك الخلاف هو فهم بعض الآيات التي تدل على نزول القرآن في وقت واحد ، مثل قوله تعالى " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"البقرة/ 185، وقوله تعالى " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " القدر/ 1 ، مع تصريح ابن عباس رضي الله عنه بذلك الفهم . عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما قالَ: أُنزِلَ القرآنُ في ليلةِ القدْرِ مِنَ السَّماءِ العُليا إلى السَّماءِ الدُّنيا جُملةً واحدةً، ثُمَّ فُرِّقَ في السِّنينَ قالَ: وتلا هذه الآيةَ"فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ"الواقعة: 75. قالَ: نَزَلَ مُتفرِّقًا."خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين -الراوي : سعيد بن جبير - المحدث : الحاكم- المصدر : المستدرك على الصحيحين -الصفحة أو الرقم : 3827 . والأثر له ألفاظ متقاربة ، ومخارج متعددة ، ولذلك صححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 4 ) وغيره . وقد اختلف العلماء في هذا النزول على أقوال أشهرها قولان: أولها : وهو قول الأكثر : أن القرآن قد نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملةً واحدة ، ثم نزل بعد ذلك منجَّمًا في ثلاث وعشرين سنة . القول الثاني : أنه ابتُدئ إنزال القرآن في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك منجَّما في أوقات مختلفة حسب الحوادث والوقائع وحاجات الناس ، وبه قال التابعي الجليل الشعبي . وهذا الخلاف – كما ترى – ليس له كبير أثر في واقع تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل إن هذا التنزيل سببه إظهار كرامة القرآن وعظيم منزلته في العالَم العلوي . موقع الإسلام سؤال وجواب . " فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا" 24.. آثِمًا : والآثم: هو الفاجر بأقواله وأفعاله.- كَفُورًا: والكفور: هو الجاحد بقلبه ولسانه. فكل كفورٍ آثمٌ ، وليس كلُّ آثمٍ كفورًا ، "وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا "سورة النساء : 48. "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"البقرة: 283. أُطلق على الشرك إثم وأطلق على معصية كتم الشهادة إثم. فدلت هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل المعاصي،سواء المخرجة من الملة أم لا. الكفور أخبث أنواع الآثام ، فخصه بالذكر تنبيهًا على غايةِ خبثهِ ونهايةِ بُعْدِهِ عنِ اللهِ . فاصبر لحكم ربك القدري واقبله، ولحكمه الشرعي الديني فامض عليه، ولا تطع من المشركين من كان منغمسًا في الشهوات أو مبالغًا في الكفر والضلال. اصبر لحكم اللّه الشرعي؛ فاصبر في كل ما حكم به ربك سواء كان ذلك تكليفًا خاصًا بك من العبادات والطاعات أو متعلقًا بالغير ، وهو التبليغ وأداء الرسالة ، حيث أُمِرَ بأن يُبلِّغ ما أُنزِل إليه من ربه، وللحكم الكوني : فاصبِرْ على ما تَلْقاه مِن أذًى في سَبيلِ ذلك، وعلى تأخيرِ نَصرِك بتحمل المشاق الناشئة من ذلك. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا :ولا تُطِعْ المعاندين الفاجرين بأقوالهم وأفعالهم ، الذين يريدون أن يصدوك عن سبيل الله ، أو الكافرين الجاحدين بقلوبهم وألسانتهم . ونهيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الآثم والكفور وهو لا يطيع واحدًا منهما، إشارة إلى أن الناس – بالأولى- محتاجون إلى مواصلة الإرشاد ، لما رُكِّبَ في طباعهم من الشهوة الداعية إلى اجتراح السيئات، وأن أحدًا لو استغنى عن توفيق الله وإرشاده لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم، ومن ثم وجب على كل مسلم ان يرغب إلى الله ويتضرع إليه في أن يصونه عن اتباع الشهوات، ويعصمه عن ارتكاب المحرمات، لينجو من الآفات، ويسلم من الزلات، ليلقى ربه أبيض الصحائف من السيئات.تفسير المراغي. عن شهر بن حوشب قال: قُلتُ لأمِّ سلمةَ : يا أمَّ المؤمنينَ ما كانَ أَكْثرُ دعاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ عندَكِ ؟ قالَت : كانَ أَكْثرُ دعائِهِ : يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ قالَت : فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ ؟ قالَ : يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ ، فمَن شاءَ أقامَ ، ومن شاءَ أزاغَ .فتلا معاذٌ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا"خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أم سلمة أم المؤمنين - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم.3522 . أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ" أتحبُّونَ أن تجتَهِدوا في الدُّعاءِ، قولوا : اللَّهُمَّ أعنَّا على شُكْرِكَ وذِكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ."خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أبو هريرة - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم.1342.. |
|
|

|
|
|
#3 |
|
نفع الله بك الأمة
|
"وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"25. "وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا" 26 . لما أمر بالصبر لحكم الله ونهَى عن طاعَةِ الآثمِ والكفورِ القاطِعةِ عن اللهِ؛ أمَرَ بمُلازَمةِ الموصِلِ إلى اللهِ – المثبت على الحق ، وهو الذِّكرُ.أي ودم على ذكره في جميع الأوقات بقلبك ولسانك وجوارحك . والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهار ، أي لا يصدك إعراضهم عن معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار، والصبر شاق ، ولا بد من الزاد والمدد المعين فذِكْر الله هذا هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك . . وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل. الذِّكر مفهومه شامل، وله معنيان: المعنَى العام للذِّكْرِ: يشمل كل أنواع العبادات من صلاة، وصيام، وحج، وقراءة قرآن، وثناء، ودعاء، وتسبيح، وتحميد، وتمجيد، وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى، وطاعته، وعبادته. قال شيخ الإسلام رحمه الله:كل ما تكلَّم به اللسان، وتصوّره القلب مما يقرِّب إلى الله من تعلّم علم، وتعليمه، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله.مجموع الفتاوى :10/ 661. معنًى خاص: وهو ذكر الله - عزَّ وجل - بالألفاظ التي وردت عن الله من تلاوة كتابه، أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تمجيد، وتنزيه، وتقديس، وتوحيد لله. الألوكة :الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح. "وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا" 26. وهذا أيضًا من عموم الذكر المعين على الثبات على الحق.وأفرد لعظيم شأنه وأثره . هذا زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتها واحدة . وموقف الباطل منها واحد ، ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل هذا الطريق . وسائل الحق تكمن في هاتين الآيتين.الذكر بكل صوره .هذا هو الزاد ، اذكر اسم ربك في الصباح والمساء ، واسجد له بالليل وسبحه طويلا . . إنه الاتصال بالمصدر الذي نَزَّلَ عليكَ القرآنَ ، وكلفك الدعوة ، هو ينبوع القوة.. . فلا تحجب روحك عن مورد الهداية. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ : قيام الليل منة عظيمة من الله لمن جاهد نفسه وطوعها لهذا الفضل العظيم المعِين .فهو دأبُ الشاكرينَ المتقينَ وهو شرفُ المؤمنِ. "أَفْضَلُ الصِّيامِ، بَعْدَ رَمَضانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وأَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ."الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم . عن عائشةَ أم المؤمنين ـ رضي الله عنها" أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هذا يا رَسولَ اللَّهِ، وقدْ غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟ قالَ: أفلا أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ "الراوي : عائشة أم المؤمنين - صحيح البخاري . قال: : أفلا أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ؟ أي: كيف لا أشكُرُه وقد أنعَمَ علَيَّ وخصَّني بخيرَيِ الدَّارينِ؟!فمَن عَظُمَتْ عليه نِعَمُ اللهِ، وجَبَ عليه أنْ يَتلقَّاها بعَظيمِ الشُّكرِ- وشكر النعم؛ يبقيها ويزيدها- لا سيَّما أنبيائِه وصَفْوتِه مِن خَلْقِه الَّذين اختارَهم، وخَشيةُ العِبادِ للهِ على قَدْرِ عِلْمِهم به. وفي الحديثِ: الحَثُّ على مُقابَلةِ نِعَمِ اللهِ عزَّ وجلَّ بمَزيدٍ مِن الاجتهادِ في العِبادةِ. قال تعالى "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"إبراهيم:7. عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنهما ، قال" جاء جبريلُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال يا محمدُ عِشْ ما شئتَ فإنك ميتٌ واعمل ما شئتَ فإنك مجزيٌّ به وأحبِبْ من شئتَ فإنك مُفارِقَه واعلم أنَّ شرفَ المؤمنِ قيامُ الليلِ وعِزُّهُ استغناؤُه عن الناسِ"الراوي : سهل بن سعد الساعدي- المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترغيب -الصفحة أو الرقم 627 : - خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره. أجر من نوى قيام الليل وغلبته عينه حتى أصبح : عن أبي الدرداء يبلغ به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَن أتى فراشَه وَهوَ ينوي أن يقومَ يصلِّي منَ اللَّيلِ ، فغلَبتهُ عيناهُ حتَّى أصبحَ كُتِبَ لَه ما نَوى وَكانَ نومُهُ صدقةً عليهِ من ربِّهِ ، عزَّ وجلَّ " .سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 20 ـ كتاب : الليل وتطوع النهار / 63 ـ باب : من أتى فراشه / حديث رقم : 1787 / ص : 290 / صحيح . فلنحرص على قيام الليل وعقد النية كل ليلة على ذلك ،فقيام الليل من أفضل العبادات التي ترفع الدرجات، وتزيد في الحسنات، وتكفر السيئات، وتقرب من رب البريات. قال ابن القيم رحمه الله : " للْعَبد بَين يَدي الله موقفان : موقف بَين يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ، وموقف بَين يَدَيْهِ يَوْم لِقَائِه ، فَمن قَامَ بِحَق الْموقف الأول هوّن عَلَيْهِ الْموقف الآخر ، وَمن استهان بِهَذَا الْموقف وَلم يوفّه حقّه شدّد عَلَيْهِ ذَلِك الْموقف " انتهى من " الفوائد " ص 200. فمن طال وقوفه في الصلاة بحقها ليلاً ونهارًا لله ، وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته ، خف عليه الوقوف يوم القيامة وسَهُل عليه ، وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة ، طال عليه الوقوف ذلك اليوم واشتدت مشقته عليه . فمن سبح الله ليلاً طويلاً ، لم يكن ذلك اليوم ثقيلاً عليه ، بل كان أخف شيء عليه . "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"السجدة:16. كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس . وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة . ابن القيم ـ الروح . إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال : قال الإمامُ عبد بن حُميد ـ رحمه الله ـ في " المنتخب " جزء : 3 / ص :170:حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا حماد بن سلمة ،عن ثابت ،عن أنس قال : كان النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا اجتهد لأحدٍ في الدعاءِ قال "جعلَ اللهُ عليكُم صلاةَ قَومٍ أبرارٍ ، يقومونَ اللَّيلَ ويصومونَ النَّهارَ ، لَيسوا بأثَمَةٍ ولا فُجَّارٍ" قال الشيخ مقبل ـ رحمه الله ـ في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين / ج : 2 / ص : 172 / كتاب الصلاة ـ باب فضل قيام الليل ، هذا حديث صحيح. أفضل أوقات القيام: يفضل تأخير صلاة الليل إلى ثلث الليل الآخر أو نصفه . عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال"يَتَنَزَّلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له."صحيح البخاري / ج : 3 /19 ـ كتاب التهجد /14 ـ باب : الدعاء في الصلاة ..... / حديث رقم : 1145 / باب : 14.
|
|
|

|
|
|
#4 |
|
نفع الله بك الأمة
|
"إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا"27.والمراد أن الذي حمل هؤلاء الكفار على الكفر ؛ والإعراض عما ينفعهم في الآخرة ليس هو الشُّبهة ؛ حتى ينتفعوا بالدلائل المذكورة في أول هذه السورة ، بل الشهوة والمحبة لهذه اللذات العاجلة، وينهمكون في لذاتها الفانية، ويَدَعون خلف ظهورهم العمل لليوم الآخر الذي ينتظرهم هنالك بالسلاسل والأغلال والسعير ، بعد الحساب العسير . فهذه الآية استطراد في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ، في مواجهة هؤلاء الذين أوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب أنها تهديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل. "نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا"28. ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي، وهو دليل الابتداء، فقال" نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ" أي: أوجدناهم من العدم، "وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ" أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وهو كناية عن الإتقان والقوة في الخلق فالمقصود بالأسر هنا: الإحكام والإتقان، والامتنان عليهم بأن الله-تبارك وتعالى- خلقهم في أحسن وأتقن خلق. ، فالذي أوجدهم على هذه الحالة، قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار. وَإِذَا شِئْنَابَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا : أي وإذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم ، والغرض منه بيان الاستغناء التام عنهم ، ونحو الآية قوله" إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيرًا"النساء :133. وقوله" إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ"فاطر:. 17-16 ثم ختم- سبحانه - السورة الكريمة بالحض على طاعته، وبالتحذير من معصيته فقال : " إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا"29."وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"30. إِنَّ هَذِهِ: المُشارُ إليهِ: السورةُ وما ذُكِر فيها . تَذْكِرَةٌ :أي يتذكَّرُ بها الإنسانُ ويتَّعِظُ، ثم ينقسم الناسُ إلى مُنتفعٍ بهذه التذكرةِ، وغيرِ منتفعٍ، ولهذا قال " فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا" وهنا قد يقول قائل: كيف قال"فَمَنْ شَاءَ"، ثم قال"وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ"؟! والجواب: أن نقول: إن مشيئة الإنسان مخلوقةٌ لله عز وجل، فهو الذي خلقها، فلا يشاء الإنسان إلا بعد أن يخلق اللّه فيه المشيئة؛ لأن اللّه خالق كل شيء، - فمجرد مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل- فمشيئة العبد وحدها لا تأتي بخير، ولا تدفع شرًا، وإن كان يُثاب على المشيئة الصالحة، ويؤجر على قصد الخير كما في حديث"إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى".صحيح البخاري. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا:بيان لكون مشيئته تعالى مبنية على أساس العلم والحكمة ، فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته.أي: إنَّ اللهَ تعالى مُتَّصِفٌ أزَلًا وأبَدًا بالعِلْمِ التَّامِّ، فلا يَخْفى عليه شَيءٌ، ومِن ذلك عِلْمُه بمَن يَستَحِقُّ الهِدايةَ فيُيَسِّرُها له، ومَن يَستَحِقُّ الغَوايةَ فيَصرِفُه عن الهُدى، وهو متَّصِفٌ أزَلًا وأبَدًا بالحِكْمةِ البالِغةِ، فيَضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه الصَّحيحِ اللَّائِقِ به، ومِن ذلك الهِدايةُ والإضلالُ.وبيَّن عز وجل أن الأمر إليه، لأجل أن نتَّجِه إلى اللّه عز وجل، وألَّا نفخر بأنفسنا إذا وُفِّقنا للطاعة، فلنعلم علم اليقين أن ذلك من كرم اللّه، ونعمته، وإحسانه. "يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" 31. أي: يُدخِلُ اللهُ مَن يَشاءُ مِن عِبادِه في رَحمتِه بتَوفيقِه لسُلوكِ طَريقِه المُستَقيمِ الموصِلِ إلى جَنَّتِه، فيختصه بعنايته، ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها، لعِلْمِه بمَن يَستَحِقُّ الهِدايةَ فيُيَسِّرُها له برحمته وفضله تعالى . وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا: وأعدَّ اللهُ تعالى عَذابًا مُؤلِمًا مُوجِعًا للظَّالِمينَ أنفُسَهم بالشِّركِ وتَرْكِ التَّوبةِ، حتى ماتوا على شركهم، وقد أملى لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا العذاب الأليم. وهذا الختام للسورة يلتئم مع مطلعها ومحورها الأساسي وهو تعريف الإنسان بحقيقته وبدايته ونهايته وضعفه وعجزة والغاية التي خُلق من أجلها وهي الاختبار والابتلاء ، ويصور نهاية الابتلاء ، الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج ، ووهبه السمع والأبصار ، وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار . نسأل اللّه أن يُنجينا ووالدينا وإياكم من عذاب النار، وأن يُدخِلنا في رحمته دار الأبرار، إنه جوادٌ كريم، والحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم تفسير سورة الإنسان - ولله الحمد والمنة
|
|
|

|
|
|
#5 |
|
نفع الله بك الأمة
|
تفسير سورة الإنسان على مدونة
منبر الدعوة |
|
|

|
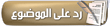 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
 (View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 1
(View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 1
|
|
| أم أبي تراب |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|